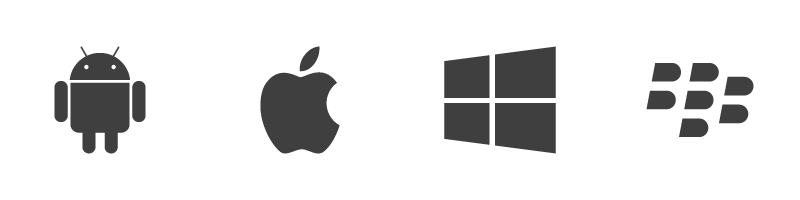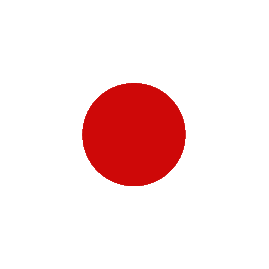
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
تحقيق | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
في سبيل الحياة ( صالح حامد)  الوسط اللبنانية | العدد التجريبي: 4362 | 24-06-2024 |
16:49
 في سبيل الحياة
لا جرمَ بأن الواجب الأوجب في نظريات التربية والتوجيه والذي يحتاجه أولادنا في الحاضر يتمثل في غرس ثقافة منتجة مثمرة تنبض بالحياة، تُحيي روح الأمل والعمل، وتعيد الاعتبار إلى قدسية الإنتاج والإبداع والعمران الحضاري، وصناعة التقدم، فما وُلِدَ مولودٌ إلا لهدفٍ وغايةٍ وغرَضٍ مرسومٍ وموصوف، فوجود الإنسان في الحياة الدنيا ليس عبثاً، بل لديه رسالة تحوي على كليات وجزئيات وأصول وفرعيات، تتجسد في عمارة الأرض، وتثبيت قانون العدالة الإنسانية، وتحقيق الرفاه الاجتماعي، تحت ظلال فقه العبادة والمعاملة، وإلاَّ ما هي الفائدة المرجوة من خلقه؟
فالواجب يفرض نفسه في الأنساق والسياقات التربوية بتكوين الإنسان الفاعل والمتفاعل، على أن يكون هذا المخلوق الرقمَ الصعب في المعادلة الوجودية، رقماً يصعب كسرُه وتجاوزه وتخطيه، ساعياً إلى إعلاء صروح الإعمار والبناء والصناعة والتقدم والاكتشاف، في سبيل حياة آمنة يشعر أهلها برغد العيش، مطاردين الفقرَ بكل مظاهره ووسائله ومحظوراته.
ومن الذي يدعي القول بأن الموت فضيلة والحياة رذيلة ؟ هذا النمط من التفكير السلبي معاذ الله أن نعزوه إلى دين أو مذهب، بل هو إيديولوجية قاتلة وغير قابلة للحياة، ومن هنا يدعونا العقل التنويري إلى حماية الأجيال من الأفكار المسمومة والداعية إلى تبني مفاهيم الموت وتحويل الأجيال إلى أحزمة ناسفة وقنابل متفجرة وآلة للقتل تحت شعار ( في سبيل الله )، فيما الله تعالى أراد أن يجعل من الإنسان محباً للدين والدنيا والآخرة، كلٌّ له قدرُه ومكانته زمانُه الصحيح.
فلعل البعض يلجأ إلى تلك المستنقعات من باب اليأس، ونتيجةً لأيديولوجيات غير قابلة للعيش والتعايش، ولعل سوء التربية والبيئة الخاطئة جعلت منه فاشلاً وفاشياً في آن واحد .
ولنعترفْ بأنَّ مناهجنا التعليمية والمنظومات الدينية فشلت في تحبيب الشباب بثقافة حياةٍ مسترشدة بروح العقل والمنطق والفضيلة، وكذلك في الانفتاح على الثقافات والفنون والآداب، وعلى التسامح وقبول الآخر، بل في الكثير من العقليات ملأت قلوب أتباعها ومريديها بأمراض بالكراهية، واستجرار التاريخ المشؤوم ووضعه في أحضان الحاضر المأزوم.
نعم، فالكراهية للحياة وللمختلف هي ثمرة فكر أجوف، ونتيجة لإيديولوجيا منغلقة، لا تقيم وزناً للحياة التي هي عطية الله سبحانه، ويقيناً فالأدبيات الإسلامية أضفت هالة قيمية على ثقافة الفرح، والسرور، والمحبة، والتسامح، ورفع الحرج، والعنت، والتيسير، والتخفيف، وإعذار الناس وإسعادها، والتمتع بالحياة وزينتها،والأدلة على ذلك كثيرة، ومنثورة في الكتب الصحاح.
فسياقات القرآن الكريم توجب علينا الشكر والامتنان على نعم الله وخيراته التي لا تعد ولا تحصى، ومنها نعمة الحياة الدنيا، لكنَّ عقلية البعض الموروثية والتقليدية حاصرَ مجتمعه بقائمة من المحرمات المنسوبة زوراً للدين والمذهب التي تنغّص جمالية الحياة على ساكنيها، ما تسبّب بنشر الجهل والفقر والتخلف والانحطاط .
فالله سبحانه خلق الموت للبعث والجزاء والبقاء، وخلق الحياة لتحقيق مراده منها، فالموت هو الحقيقة الأبقى، والمخلوق بقدرة وإردة الله ومشيئة الله سبحانه، كما جاء في مقدمة سورة الملك، ومعه يشعر الإنسان بالضعف والخوف والحذر والزهد في الباطل الحرام.
فالموت عبارة أن الروح فارقت البدن، وارتحلت إلى خالقها وعالمها الجديد، والجسد عاد إلى أصله الترابي، الذي منه خُلِقَ وإليه يعود. فعندما غرغرتِ الروحُ من سجن الجسد، هنا تعطلت أجهزة الجسم عند الإنسان، فتموت كل خلية من خلاياه، وتتحلل أنسجة الجسم، وتتحول إلى تراب التي تكوّن منها في أصل نشأته. فالموت يحول الإنسان من متحرِّك إلى جامد لا حس ولا حركة ولا تنفس ولا قلب ينبض. فالموت أجل محتوم معلوم، وله ملائكة متخصصون.
فيا سبحان الله، فالحياة تبدأ بنفخة الروح في الجسد، والموت تنتهي مهمتُه بنزع الروح، وانتقالها من عالم إلى عالم مختلف غير متشابه، وأفعال الله هادفة ومعللة بالأغراض.
فالموت مكروه لكل حي، والجميع يهابه ويخافه ويحاذره، لكنه محتوم لا مفر منه، وهو دليل على إظهار القدرة الإلهية في الإماتة، وكذلك فإن الإحياء تتجلى فيه القوة الربانية في دقة الصنع والتكوين وبأحسن تقويم، ونسأل الله حسن الختام والوفاة على الإيمان .
صحيح، فهناك أدبيات تراثية تبالغ في ذم الحياة وبهجتها، والتحذير من فتنتها، والترويج لأحاديث واهية بأن حب الدنيا رأس كل خطيئة، وتركز على ثقافة الموت وعذابات القبر وأهوال يوم القيامة، وتصوير الحياة كأنها سجن للمسلم، وهذه إشكالية يصار لحلها والرد عليها، بمفاهيم تحاكي العقل والمنطق ومنطوق الشريعة ومقاصدها السامية .
ففي علم أصول الدين وعلم الكلام، أنَّ الدنيا معبر للآخرة، والحياة محددة بالأجل، كما ورد في الآية الكريمة (لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ).فالموت عبارة عن إعلان نهاية الأجل وانقضاء العمر. فأصول الفقه هو العلم الوحيد الذي فضّل الحياة على الموت.
فالحفاظ على العيش هو الضرورة الأولى من الضروريات الخمس وهي : الحياة، والعقل، والدين، والعرض، والمال. فالضرورات تبيح المحظورات، والرخص بدائل للعزائم، والمصالح المرسلة وجميع أشكال الاستدلال الحر من استحسان واستصلاح واستصحاب تهدف إلى الحفاظ على الحياة، ودرء خطر الموت.
إنَّ الموت يدفع الناس إلى الحياة، ويجعل الزمن مركزاً ومحدداً للإبداع، فلا إبداع إلا داخل الزمان، بعدها يتحول الإبداع إلى خلود كجزء من الإبداع البشري العام. والخلود رغبة في البقاء وقهر الموت.
ولا نجافي الحقيقة إنْ قلنا بأنّ الغرب تفوق علينا في ميادين عديدة،خصوصاً في بداية عصر النهضة والتنوير وإلى وقتنا الحالي، لأنه آثر الحياة على الموت، وتحوّل محور الفكر الأوروبي من النفس إلى البدن، ومن طهارة الروح إلى طهارة الجسد، وإلى نظافة الطريق والحمامات والملابس. فنشأت لديه فلسفات الحياة منذ سقراط عند اليونان، وأغسطين في عصر آباء الكنيسة ودلتاي وبرجسون وهوسرل وأوكن وأورتيجا وفوكو وجيو ونيتشه. وعشقوا مظاهر الحياة ومنها الفن في مدرسة " الفن للحياة " وعبرت الرومانسية عن عشق الحياة والوله بها، وجعلت الموت حياة.
فلا علمَ ولا قدرةَ دون حياة، ولا علم ولا قدرة إلا لحي، (وَتوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لا يَمُوتُ). وهو اللفظ المكرر في رياضات الزهاد ومجاهداتهم للنفس " حي... حي... حي ". كما ورد اللفظ في القرآن الكريم كصفة للإنسان والنبات.
فالحياة بينة وبرهان ووعي معرفي، (لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ). والقرآن الكريم إذن ثقافة حياة، وليس ثقافة موت. فكيف تستطيع الأمة أن تعود إلى القرآن من جديد لتغير ثقافة الموت الموروثة عبر التاريخ من فلسفة الزهد وعلم الكلام إلى ثقافة الحياة الأصيلة التي تحتاجها الأمة اليوم كي تحيا من جديد؟
لا شك بأن القراءة السطحية للنصوص الدينية لا تنفذ إلى سبر أغوار الحقيقة، بل تفتقر إلى كثير من التحاليل والتأمل والمقارنة، فالنظرة المغلوطة تحرف الرسالة عن منطلقاتها ومقاصدها، وينتج عنها ممارسات وسلوكيات مغايرة من حيث الحقائقُ والأبعادُ والغايات .
ولنتصارح، أنه بالممارسة والفعل هذا ما مُني َبه الإسلامُ على يد بعض التيارات والمذاهب التي ذهبت به إلى غير مراميه، وأضفت عليه شروحات وتفسيرات وتأويلات لا تنسجم مع روحه وحقيقته، وقد ساهم المروجون لهذه التيارات والمذاهب في إسقاط تفسيراتهم وآرائهم على العامة التي تلقفتها تلقُّف المسلَّمات، فتحولت إلى سلوك وممارسة رسخت صورة التشوه وحولتها إلى حقيقة يُحاكَم الإسلام ُعلى أساسها.
فمما ما لا يقبل الشك والتأويل أن القيم الإسلامية لم تنظر الى " الدنيا " نظرة سلبية مطلقة، ولم يدع الإسلامُ معتنقيه الى البراءة من الدنيا والزهد فيها بمعنى تركها والتخلي عنها، ولم ينظر الى من حاز على شيء من زينتها أو متاعها نظرة ريب أو جحود.
نعم، قد يعترض البعض على هذه النتيجة مستدلاً بما لا بأس به من الآيات التي تذم الدنيا وتحذر منها وتدعو الى التخلي عنها والبراءة منها، لكنّ التوفيق والموازنة بين الآيات والأحاديث الداعية للزهد والتخلي وما بين الآمرة بعمران الحياة بالعلم والصناعة والزراعة ،وبالأخذ بأسباب النجاح والتقدم والتفوق وبما فيه خير البشرية، تقتضي الخروج بنتيجة منطقية وهي أن النهي الوارد عن طلب الدنيا إنما هو نهي عن طلبها بالطرق والوسائل المحرمة وغير المشروعة، فالمذموم في الدنيا بمعنى الانكباب عليها واللهث وراء شهواتها الرخيصة والعبودية المطلقة لها بما يكون على حساب الآخرة، وبما يسقط الانسان من مصافي الانسانية السوية المتميزة بالعقل الى مهاوي البهيمية التي تخضع تحت وطأة الغرائز والرغبات.
وليعلم الجميع، أن طلب الدنيا والسعي وراء لقمة العيش الحلال فرض وواجب ديني وأخلاقي واجتماعي لا مناصَ منه، والله حذرنا من العطالة والبطالة والكسل والجبن والبخل والاتكالية.
فالإيديولوجيات المصطنعة والداعية إلى الموت بمناهج وطرق متعددة، لا تصلح أن تسمى ديناً او مذهباً،بل نهج يعبر عن مرض عضال تدعو الحاجة والضرورة إلى معالجته بالحكمة والموعظة الحسنة. بل يقيناً فتلك المناهج الميتة تصنع مجتمعاً ميتاً لا روحَ ولا خيرَ فيه.
وآسف القول، فإن بعض المناهج والإيديولوجيات تجهر ليلاً ونهاراً بأنّ الموت غايتنا، بل وشعاراتها ويافطاتها تحث على العنف والموت، والمنطق يقول بأنَّ تلك الأفكار لا يمكن أن نتعايش مع معتنقيها، فالخلاف بين الثقافتين بينهما هوة وفجوة لا يمكن سدها وملؤها .
فالعقل الإسلامي الرشيد يأخذ بيدنا نحو حياة نقية من الأخطاء، وصافية من المساوئ، وجميلة بالتأمّل، وخالية من النكد والشظف والمنغصّات، ومشيّدة بالعمران الحضاري، حيث يشعر الإنسان عليها بالتكريم، يتلذذ بأيام عمره لحظة بلحظة، ضمن منظومة الحلال والمباح.
وعلينا التفريق بين الإيديولوجيات الداعية للموت، وما بين الإيديولوجية التي تدعو إلى حماية النفس ومشروعية الدفاع في وجه قاتليها، فالدفاع عن النفس والأرض والعرض واجب ديني ووطني لا خلاف عليه، لكنّ النظر في إشكالية الدفاع ورد العدوان وردعه أمر تتباين فيه الآراء، لكنّ الرأي الأقرب للصواب هو أن منظومة القتال والدفاع وإعلان الحرب والتعبئة أمرٌ محصور بالدولة الرسمية وبدوائرها الشرعية، فالدولة بكافة وزاراتها هي المسؤولة في البداية والنهاية عن إقامة منظومة دفاعية لحماية مواطنيها وتأمين سلامتهم، ونصرة قضاياهم ودعم صمودهم أينما كانوا وارتحلوا.
فالدولة وحدها لا شريك لها من واجبها طمأنة مواطنيها عبر جيشها الوطني وأجهزتها الأمنية الموحدة، فهي الأم التي تحضن أولادها، والأب الخادم لحاضرهم ومستقبلهم. فالعقد الاجتماعي دستور مبرم بين مكونات الشعب على التعايش السالم القائم على الاحترام.
وإنّ التعبئة الدينية القائمة على غرس ثقافة الموت في نفوس الأجيال، لهَو أمرٌ تنفر منه الطباع البشرية والعقول السلمية، ولا يلجأ إليه إلاّ المفلسون، بل هو خطابٌ يُنشئ جيلاً عدواً لنفسه ومجتمعه ووطنه، ويسهل استغلاله واستهباله والاسثمار في عواطفه الطائفية .
فالإنسان ولِدَ ليحيا ولِيَبنيَ وليرفعَ قواعدَ العمرانِ الحضاري، ويعمل على استصلاح الأرضي وريّها، وعلى استثمار واستكشاف ما في السماوات الأرض، وتسخيرها في خدمة الإنسانية.
ولا ننسى أن النفس في الجسد أمانة ربانية، أودعها الله بين يدي الإنسان، فلا يجوز إهلاكها وإيذاؤها، أو تعريضها للمخاطر والموبقات أو التفريط بها، وهنا أكرر بأن مواضيع إعلان الحرب والجهاد والتعبئة والقتال والاستنفار وغيره شأنٌ محصور بالدولة ومؤسساتها الوطنية فقط لا غير. لذا فحب الحياة جزء من عقيدة المسلم، فيما الموت هو العقيدة كلها .
المصدر: الوسط اللبنانية ووكالات 
| |||||||||||||||||||||||||||